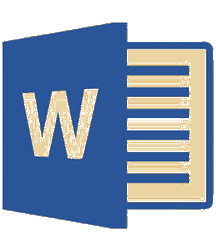حكم الهجرة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بدايةً اختلف أهل العلم في بقاء حكم الهجرة، وهل هي باقية أم أنها نسخت؟ على قولين:
القول الأول: أن الهجرة باقية وغير منسوخة، وهو قول الجمهور.انظر: المنتقى شرح الموطأ 6/156، والحاوي الكبير 14 / 222، وتحفة المحتاج 9/ 269، وتكملة المجموع 19 / 265، والمغني 10/505، ومطالب أولي النهى 2/ 511، والعدة شرح العمدة 1 / 592، وسبل السلام 2/ 1185، ونيل الأوطار 8/34.
واستدلوا بجملة من الأحاديث الدَّالة على بقاء الهجرة وعدم انقطاعها، ومنها الآتي:
أولا: حديث مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ). أخرجه أحمد (16301)، وأبو داود (2120)، والدارمي (2401)، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل 5 / 33.
ثانيا: حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَقْدَانَ السَّعْدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: "وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفْدٍ كُلُّنَا يَطْلُبُ حَاجَةً، وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَرَكْتُ مَنْ خَلْفِي، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ.
قَالَ: ( لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ ). أخرجه النسائي (4102)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (4173).
ولأحمد: ( إِنَّ الْهِجْرَةَ لَا تَنْقَطِعُ مَا كَانَ الْجِهَادُ ). أخرجه أحمد (16002) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 4 / 239.
وجه الاستدلال:
هذه الأحاديث ظاهرة الدلالة في كون الهجرة لم تنقطع، وأنها باقية ما دام الجهاد قائما، ومقاتلة الكفار قائمة.
القول الثاني: أن الهجرة نسخت، وأن حكمها قد انقطع، وهو قول الحنفية.المبسوط 1/41، وبدائع الصنائع 1/158، ورد المحتار على الدر المختار 6/769.
الأدلة:
أولا: عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ( لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ). أخرجه البخاري (2575)، ومسلم (3469).
ثانيا: عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنْ الْهِجْرَةِ؟ فَقَالَ: ( وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ ) قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟
قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ( فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا ). أخرجه البخاري (5699)، ومسلم (3469).
ثالثا: عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه انْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعْبَدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ: ( مَضَتْ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا .. عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ ). أخرجه البخاري (2742)، ومسلم (3465)، واللفظ للبخاري.
ولمسلم: ( وَلَكِنْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ ). أخرجه مسلم (3465).
رابعا: عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: زُرْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، فَسَأَلْنَاهَا عَنْ الْهِجْرَةِ؟
فَقَالَتْ: "لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ، كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ، وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ". أخرجه البخاري (3611)
وعن عَطَاءً قال: ذَهَبْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ بِثَبِيرٍ، فَقَالَتْ لَنَا: ( انْقَطَعَتْ الْهِجْرَةُ مُنْذُ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ). أخرجه البخاري (2850).
مناقشة الأدلة السابقة:
جاء في مناقشة هذه الأدلة الآتي:
قال الطيبي وغيره في قوله: ( ولكن جهاد ونية ): " الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن، التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة، كالفرار من دار الكفر، والخروج في طلب العلم، والفرار بالدِّين من الفتن، والنية في جميع ذلك معتبرة". فتح الباري 6/39.
وقال ابن قدامة: "إن الهجرة قد انقطعت يعني من مكة؛ لأن الهجرة الخروج من بلد الكفار، فإذا فتح لم يبقَ بلد الكفار، فلا تبقى منه هجرة، وهكذا كلُّ بلد فتح لا يبقى منه هجرة، وإنما الهجرة إليه إذا ثبت هذا". المغني 10/505.
وعليه فغاية ما تدل عليه هذه النصوص هو انقطاع الهجرة من مكة بعد فتحها على أنها دار كفر، أما مطلق الهجرة فحكمها باقٍ كما بيَّنته أدلة الجمهور.
والسبب في هذا الخلاف كما يبدو هو ما يظهر من جنس تعارض يسير بين النصوص التي تبين أن الهجرة قد انقطعت، ونسخ حكمها، وبين النصوص الأخرى التي تبين كونها لم تنقطع.
وقد اختلفت طرائق الفقهاء في الجمع بين تلك الأحاديث على ثلاثة أقوال:
الأول: أن الهجرة كانت في أول الإسلام مندوبا إليها، ثم فرضت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما فتحت مكة ارتفع وجوب الهجرة، وعاد الأمر فيها إلى الندب والاستحباب، فهما هجرتان: المنقطعة هي المفروضة، والباقية هي المندوبة، وهو قول الحنفية، واختاره الخطابي.معالم السنن 3/ 352، ومرقاة المفاتيح 4/ 182، والمبسوط 10/ 6.
الثاني: أن الهجرة من مكة إلى المدينة ارتفعت يوم الفتح؛ لأن مكة صارت يوم الفتح دار إسلام، وكانت الهجرة عنها قبل ذلك واجبة؛ لكونها مساكن أهل الشرك، فمن حصل عليها فاز بها وانفرد بفضلها دون من بعدهم، وهذا هو الفرض الذي سقط.
أما الهجرة الباقية الدائمة إلى يوم القيامة فهي هجرة من أسلم بدار الكفر؛ إذ يلزمه أن لا يقيم بها حيث تجرى عليه أحكام الكفار، وأن يهاجر ويلحق بدار المسلمين حيث تجرى عليه أحكامهم.المقدمات الممهدات 2/ 153، وشرح السنة 7/ 295، 10/ 373، وعارضة الأحوذي 7/ 88، ونيل الأوطار 7/ 26، وفتح الباري 6 / 39، وشرح النووي على مسلم 13/ 8.
الثالث: أن الهجرة الفاضلة التي وعد الله عليها بالجنة، كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدع أهله وماله، لا يرجع في شيء منه، انقطعت بفتح مكة، أما الهجرة الباقية فهي هجر السيئات، لجملة من الأحاديث فيها أن الهجرة هي هجرة السيئات.منها: حديث: ( المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ) أخرجه البخاري (9)، وحديث: ( المهاجر من هجر الخطايا والذنوب ) . أخرجه أحمد (22833)، وابن ماجه (3924)، وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته 1 / 1161. انظر: طرح التثريب 2/ 23-24، وعمدة القاري 11/ 318.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجمع بين الأحاديث:
"فالأول أراد به الهجرة المعهودة في زمانه؛ وهي الهجرة إلى المدينة من مكة وغيرها من أرض العرب؛ فإنّ هذه الهجرة كانت مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب، وكان الإيمان بالمدينة، فكانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة لمن قدر عليها، فلما فتحت مكة وصارت دار الإسلام، ودخلت العرب في الإسلام صارت هذه الأرضُ كلُّها دار الإسلام، فقال: "لا هجرة بعد الفتح"، وكون الأرض دار كُفْر ودار إيمان، أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها، فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت، فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم". مجموع الفتاوى 18/281.
وقال ابن العربي رحمه الله: "الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت بعده لمن خاف على نفسه، والتي انقطعت أصلاً هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان". نقله عنه في سبل السلام 2/463.
الترجيح:
بعد النظر في أدلة الفريقين وما أورد من مناقشة على قول الحنفية، وبعد ما ذكر من طرق العلماء في الجمع بين تلك الأدلة يترجح قول الجمهور، وأن الهجرة باقية لم تنسخ.
وذلك للوجوه الآتية:
1- قوة أدلة الجمهور، وتوافرها في أن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، فعلقها الشارع بأمرٍ مؤبَّد.
2- إمكان حمل أدلة الحنفية على هجرة مخصوصة، وهي الخروج من مكة باعتبارها دار كفر، وذلك لما تحوَّلت إلى دار إسلام، فالمنفي هجرة خاصة وليس مطلق الهجرة.
3- أن قاعدة النظر المطردة: أنه متى أمكن الجمع بين النصوص وجب المصير إليه، دون القول بالنسخ الذي يترتب عليه إبطال أحد نصوص الشرع، ومعلوم أنه لا سبيل للأخذ بقول الحنفية إلا على وجهٍ من الإِبطال لأدلة الجمهور، وهذا غير سائغ شرعا، فتعين الجمع بين النصوص على نحو من الطُّرُق السابقة، ولعل أقواها أن يقال: الهجرة من مكة باعتبارها دارَ كفرٍ منسوخ، وذلك لتحوُّلها دار إسلام، أما مطلق الهجرة فمشروع، والله أعلم.
ثم إن الذين قالوا ببقائها، وعدم انقطاعها اختلفوا فيها، واختلافهم إنما هو فيما إذا كان الشخص مقيما، أو مستوطنا بدار الكفر: ما حكم الهجرة في حقه؟
تحرير النزاع:
أولا: اتفق أهل العلم على أن المسلم الذي يقيم بين أظهر المشركين إذا خاف الفتنة وعجز عن إظهار دينه، أنه لا يجوز المقام بينهم، وتجب عليه الهجرة، وإذا كان هذا ثابتا في مجرد الإقامة، ففي الاستيطان من باب أولى. أسنى المطالب 4/ 203، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج 9/270، والشرح الكبير لابن قدامة 10/379، وشرح منتهى الإرادات 4/162، وكشاف القناع3/109، ومختصر الفتاوى المصرية (505).
ثانيا: اختلف كلام أهل العلم في المسلم الذي يُقيم بين أظهر المشركين مع قدرته على إظهار دينه، وعدم خشية الفتنة، فحكى الماوردي أن حكم الهجرة في هذه الحال لا يخلو من أقسام خمسة:
أحدها: أن يقدر على الامتناع في دار الحرب بالاعتزال، ويقدر على الدعاء والقتال، فهذا يجب عليه أن يقيم في دار الحرب؛ لأنها صارت بإسلامه واعتزاله دار الإسلام، ويجب عليه دعاء المشركين إلى الإسلام بما استطاع من نصرته بجدال أو قتال.
الثاني: أن يقدر على الامتناع والاعتزال، ولا يقدر على الدعاء والقتال، فهذا يجب عليه أن يقيم ولا يهاجر؛ لأن داره قد صارت باعتزاله دار إسلام، وإن هاجر عنها عادت دار حرب، ولا يجب عليه الدعاء والقتال لعجزه عنها.
الثالث: أن يقدر على الامتناع، ولا يقدر على الاعتزال، ولا على الدعاء والقتال، فهذا لا يجب عليه المقام؛ لأنه لم تصر داره دار إسلام؛ ولا تجب عليه الهجرة؛ لأنه يقدر على الامتناع، وله ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يرجو ظهور الإسلام بمقامه، فالأولى به أن يقيم ولا يهاجر.
الثاني: أن يرجو نصرة المسلمين بهجرته، فالأولى به أن يهاجر ولا يقيم.
الثالث: أن تتساوى أحواله في المقام والهجرة، فهو بالخيار بين المقام والهجرة.
الرابع: ألا يقدر على الامتناع، ويقدر على الهجرة، فواجب عليه أن يهاجر وهو عاصٍ إن أقام، وفي مثله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل: ولم يا رسول الله، قال: لا تراءى ناراهما ). أخرجه الترمذي (1530)، وأبو داود (2274)، والنسائي (4698)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (2645).
قلت: وهذا خرج في محل النزاع.
الخامس: أن لا يقدر على الامتناع، ويضعف عن الهجرة، فتسقط عنه الهجرة لعجزه، ويجوز أن يدفع عن نفسه بإظهار الكفر، ويكون مسلما باعتقاد الإسلام والتزام أحكامه، ولا يجوز لمن قدر على الهجرة أن يتظاهر بالكفر؛ لأنه غير مضطر، والعاجز عن الهجرة مضطر، ويكون فرض الهجرة على من آمن فيها باقيا ما بقي للشرك دار.الحاوي الكبير 14/222، وما بعدها، وانظر: تحفة المحتاج 9/269 ط. إحياء دار التراث العربي، وحاشية الجمل 5/209.
ثم هذه الأقسام فيما إذا كانت الدار التي يهاجر منها دار كفر، أما دار المعاصي، فإنه لا تجب الهجرة منها، إنما تندب.حاشية الجمل 5/209، وشرح منهى الإرادات 4/162، وكشاف القناع 3/38 .
أما ابن قدامة رحمه الله فقد ساق هذا بشكل آخر، فقال رحمه الله: فالناس في الهجرة على ثلاثة أضرب:
أحدها: من تجب عليه وهو من يقدر عليها، ولا يمكنه إظهار دينه، ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة لقول الله تعالى: ] إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَئِكَةُ ظَالِمِى أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى الأرْضِ قَالْواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً [ النساء-97.
وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب؛ ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته؛ وما لا يتم الواجب به فهو واجب.
الثاني: من لا هجرة عليه، وهو من يعجز عنها إما لمرض، أو إكراه على الإقامة، أو ضعف من النساء والولدان وشبههم، فهذا لا هجرة عليه لقول الله تعالى: ] إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ]98?[ فَأُوْلَـئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوّاً غَفُوراً [النساء-98/99، ولا توصف باستحباب؛ لأنها غيرُ مقدورٍ عليها.
الثالث: من تستحب له ولا تجب عليه، وهو من يقدر عليها، لكنه يتمكن من إظهار دينه وإقامته في دار الكفر، فتستحب له ليتمكن من جهادهم، وتكثير المسلمين ومعونتهم، فيتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم، ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة.المغني 10 / 505.
بناء على ما تقدم في كلام الماوردي أو ابن قدامة، فإن الهجرة من ديار الكفر حكمها يختلف باختلاف حال الأشخاص المقيمين فيها، فقد تجب، وقد تباح، وقد تستحب، بل وقد يتحتَّم على المسلم البقاء في دار الكفر فيما إذا كان يقدر على إظهار الدين، ودعوة الكفار إلى الإسلام، أو كان يرجو ظهور الإسلام بمقامه، وقد استدل صاحب مغني المحتاج لهذا بأن إسلام العباس رضي الله عنه كان قبل بدر، وكان يكتمه ويكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين، وكان المسلمون يتقوُّون به بمكة، وكان يحب القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه صلى الله عليه وسلم: ( إن مقامك بمكة خير )، ثم أظهر إسلامه يوم فتح مكة.مغني المحتاج 6 / 55، وانظر: أسد الغابة 2 / 76، وتهذيب الأسماء 1 / 352.
ولا شك أن هذا ليس لكل أحد، ويظهر لي أن أغلب الناس سريع التأثر بما عليه الكفار، وخاصَّةً في هذا الزمان الذي غلب فيه أهل الكفر، وشاع لدى بعض المسلمين تقليد الكفار، واتباعهم وهم في ديار الإسلام، فكيف الحال بمن هو مقيمٌ بين أظهرهم؟! فلا شك أن الفتنة أعظم والخطر أكبر، وأحكام الشريعة مبنية على الغالب الكثير لا على النادر القليل، والله أعلم.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 23/2/1430هـ
***